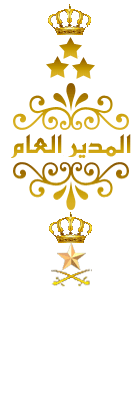ومن يومها أطلق الإمام حسن البنا على الشيخ الغزالي لقب ” أديب الدعوة ”.
الشيخ محمد الغزالي الداعية الأديب
رحل الشيخ
محمد الغزالي ـ رحمه الله ـ إلى ربه فجأة، تاركاً وراءه رصيداً كبيراً من
الكتب والمقالات والدراسات الفكرية، وتجربة غنية في مجال الدعوة إلى الله،
في هذا القرن الذي شهدت فيه الأمة الإسلامية تحديات عظيمة، كان أعظمها سقوط
الخلافة الإسلامية، ثم هذا التردي الحضاري الذي يعيشه المسلمون ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]يوم
بعدما تركوا قيم الإسلام ومبادئه، ثم إنهم تركوا زمام المبادرة إلى أمم
أخرى لتصنع التاريخ، وتبني المدنيات وفق المناهج الوضعية، فكان أن هيمنت
الفلسفات المادية، وسادت النظريات الغربية التي لا تعترف لله بسلطة أو
وجود، وقد ظل الشيخ الغزالي بما حباه الله من عمق في الفكر، وسعة في الصدر،
وبعد في النظر، يصارع تلك الفلسفات الغريبة، والأنظمة الملحدة، داعياً إلى
تصحيح المنهج، وتقويم التصور، والعودة إلى ينابيع الإسلام الصافية. وظل
الشيخ طوال خمسين سنة مرشداً للصحوة الإسلامية، ومدافعاً عن الإسلام في
معاركه مع القوى المضادة، وظل يدعو إلى الفهم السليم في التعامل مع القرآن
الكريم والسنة النبوية والتراث الإسلامي العريض، هذا مع الاستفادة من
معطيات العصر النافعة في مجال العلوم والتقنية الحديثة.
وترك
ـ رحمه الله ـ مكتبة ضخمة من الكتب الفكرية، والدراسات الدعوية التي يجد
فيها الناس والدعاة بشكل خاص الفائدة الفكرية، والمتعة الوجدانية، وذلك لما
تميزت به هذه الكتب من فخامة في الأسلوب، وبراعة في الإنشاء، وجمال في
التعبير.
رصيد الداعية ولغة الخطاب:
إن الحديث عن
تجربة الشيخ الغزالي الواسعة في مجال الدعوة الإسلامية، وجهوده خلال فترة
زمنية زادت على نصف قرن أمر قد تستوعبه أكثر من دراسة علمية متخصصة، وفي
هذا المقال لن نسلط الضوء على هذا الجانب، بل سيكون الحديث حول جانب آخر
برع فيه الشيخ وهو توظيف الأدب في خدمة الدعوة، سواء أكان ذلك في لغة
الخطاب والمحادثة أم في مجال التعبير بالكتابة، وهو من الجوانب التي لا
يحسنها كثير من الدعاة، ذلك أن الدعوة الإسلامية هي كلمة تقال، وفكرة تثار،
فإذا أحسن الداعية التعبير عنها مع وجود عناصر الإخلاص والصواب والقدوة
الحسنة آتت الدعوة أكلها بإذن الله تعالى، وأدت وظيفتها في مجال تغيير
النفوس وبنائها.
وإذا تحدثنا بإنصاف عن الشيخ فإننا سنجده قد وفق أيما
توفيق في التعامل مع الكلمة وطرق أدائها، واختيار الوسائل الخطابية التي
تناسب الناس في هذا العصر الذي تنوعت فيه الثقافات، وامتزجت فيه الأفكار،
وأصبح التفاوت بين الناس واضحاً في جميع مستويات الحياة الفكرية والثقافية،
أذكر منذ فترة وأنا شاب ممتلئ بالحماسة الإسلامية كنت أتطلع إلى معرفة بعض
الجوانب المشرقة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فوقع بين يدي كتاب
للشيخ الغزالي اسمه “فقه السيرة” وبعد أن قرأت منه بعض الصفحات شدني أسلوبه
الأدبي الرائع وطريقة عرضه لحلقات السيرة الشريفة، فقد كان الأسلوب يجمع
بين عمق الفكرة وجمال التعبير، وقد بدا واضحاً لي أن الشيخ حريص على تقديم
السيرة النبوية بأسلوب أدبي شائق يحقق الإقناع والإمتاع في آن واحد، ذلك
لاقتناعه التام بضرورة التجديد في أساليب الخطاب تلبية لحاجات الناس
وأذواقهم في هذا العصر.
وعلى غرار فنه الأدبي الجميل في الكتابة عُرف
الشيخ بفصاحة اللسان، وبراعة الخطابة، وحسن الإلقاء، وأذكر في هذا المقام
تلك الدروس التي كان يقدمها في التلفاز الجزائري، وعُرفت «بحديث الإثنين»،
فقد كان يتابعها آلاف الناس، حتى أولئك الذين لم يؤتوا حظاً من الثقافة،
وحين تسأل عن سر ذلك النجاح يقال لك: إنه سحر الكلمة، وصدق العاطفة، وجمال
الأدب.
الأدب في خدمة الدعوة:
إن المتابع
لكتابات الشيخ لابد أن يلحظ أن جلها مطبوع بالطابع الأدبي، وإن كان موضوعها
هو الفكر والعقيدة والدعوة الإسلامية، ويتجلى هذا الطابع الأدبي في
جانبين:
أولهما: توظيف النماذج الأدبية الراقية في خدمة الفكر الإسلامي.
ثانيهما: اختيار الأسلوب الأدبي الجميل في التعبير والإنشاء.
أما
الجانب الأول فإن الشيخ كثيراً ما كان يوظف النماذج الأدبية الراقية، سواء
أكانت شعراً أم نثراً، في خدمة فكرة يريد بثها، وغرسها في النفوس، فهو
يختار بحسه الأدبي ما يراه مناسباً من الموروث القديم، ومن الإنتاج الحديث،
ويمزجه بالحقائق الدينية ويعرضه في وقته ومكانه المناسبين، ليلائم به
أذواق الناس ويلبي حاجتهم إلى القيمة الفكرية والمتعة الأدبية، وهو يدرك
بلاشك أن الأدب في هذا العصر أصبح بفنونه وأساليبه المختلفة يجذب قطاعاً
عريضاً من الناس، وأصبح الذوق بشكل عام ميالاً إلى اكتساب المعرفة والثقافة
بطرق فيها يسر واقتصاد، وفيها ـ أيضاً ـ جاذبية وإمتاع.
إن الخطاب
الفكري والدعوي في حاجة ماسة إلى لغة تخاطب العقل والوجدان، لتدخل إلى
النفوس من منافذها المختلفة، وتحقق غايتي الإقناع والإمتاع ـ سيراً على نهج
القرآن الكريم وأسلوبه الفريد ـ ذلك أن الإبداع في اللغة حاجة يقتضيها كل
عصر، وبخاصة في عصرنا الحالي الذي عرفنا فيه أنواعاً من الألوان الأدبية،
والثقافات المتباينة، هذا بالإضافة إلى تلك التغييرات التاريخية الجذرية،
والأحداث الكبرى التي حدثت فيه، وأصبح هذا العصر كما يقول مالك بن نبي ـ
رحمه الله ـ كأنه النهر قرب شاطىء البحر، وقد بلغ المصب بعد أن تجمعت فيه
جميع روافده من المياه التي انحدرت من أعالي الجبال في أقصى داخل
البلاد.(2) ومع هذا الركام من الثقافات، والصراع بين الأفكار، والتفاوت بين
المجتمعات، كان لابد من التجديد في الوسائل والطرق الدعوية التي من شأنها
أن تكسب روح الجماعات، سواء أكانت إسلامية أم غير إسلامية، واللغة هي أداة
الفكر، وهي الوسيلة الأساسية المستخدمة في مجالات الدعوة والإعلام،
والتغيير والبناء، ولأهميتها الكبيرة حرص الشيخ في الجانب الثاني على
اختيار اللغة الجميلة، والأسلوب الأدبي اللطيف في الكتابة والتعبير.
حين
كتب الشيخ كتابه «عقيدة المسلم» دعا إلى عرض العقيدة الإسلامية بأسلوب
يجمع بين فخامة اللغة وجمالها، ودقة المعنى ووضوحه لتميل إليها النفوس،
وتعلق بها القلوب، وقد حرص على تطبيق هذه الدعوة في كتابه هذا مخالفاً بذلك
كثيراً من العلماء قديماً وحديثاً، ممن كانوا يعرضون العقيدة في قوالب
جامدة، وأساليب عقيمة، بل كثيراً ما كانوا يقحمون خلافات أهل الكلام،
واختلافات أهل الجدل حول مسائل العقيدة في كتبهم، فكيف يكون حال متلقي
العقيدة من هذا كله؟ إنه مثل الصياد الجائع الذي يقضي نهاره في اللهث وراء
الأسماك السابحة في النهر، وفي آخر النهار يذهب بخفي حنين.
يقول في هذا ـ
رحمه الله ـ: «إذا كان علم التوحيد على النحو الذي وصفنا (3)، فإن كتبه
التي تشيع بيننا الآن فشلت في أداء رسالتها شكلاً ومضموناً، فمن ناحية
الشكل لا معنى ألبتة لعرض علم ما في توزيع مضطرب بين متن وشرح وحاشية
وتقرير، وفي لغة ركيكة، سقيمة الأداء، لغة تصور سقوط البلاغة العربية في
عهد الحكم التركي».(4)
ثم يتحدث عن أهمية الأدب في هذا العصر، وعن
وظيفته المفقودة عندنا حين نحاول عرض العقيدة وتقديمها للناس، في حين تجد
أصحاب العقائد المنحرفة يعرضونها في أجمل صورة، يقول: «تطور الأدب في عصرنا
هذا لا ينكر، وقد بلغ من تمكن المؤلفين والمتأدبين في اللغة أن تناولوا
الموضوعات التافهة فأخرجوها في ألبسة زاهية، ووجهوا ألوف القراء ـ بسحر
بيانهم ـ إلى ما يريدون، فهل يبقى الكلام في العقائد حكراً على هذا النمط
من الحواشي والمتون».(5)
لقد كان الهم الذي يراود الشيخ هو الوصول
بالفكر الإسلامي إلى شغاف القلوب، وأداء واجب الدعوة إلى الله بالمنهج الذي
حدده القرآن الكريم في قوله تعالى: {ادعُ إلى سبيل رَبّك بالحكمة والموعظة
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} (سورة النحل الآية 125) وبالسبيل الذي حدده
الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليه في حياته «إن من البيان لسحرا، وإن
من الشعر لحكمة» (حديث صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ)، وأن من يتعامل مع
كتابات الشيخ سيجد تأثراً كبيراً بمصدري الإسلام: القرآن والسنة النبوية،
وبروائع الكلام في تراثنا الإسلامي الكبير، وهذا ما أكسب أسلوبه جمالاً في
العرض، وبراعة في التمثيل، ولطافة في التعبير، انظر إليه وهو يدافع عن قضية
التنويع في أساليب القرآن الكريم ـ وقد عدها بعض المستشرقين عيباً ونقصاً
فيه ـ والمقام هنا مقام استدلال ومحاجة، يقول: «إن القرآن لوّن حديثه
للسامعين تلوينا يمزج بين إيقاظ العقل والضمير معاً، ثم تابع سوقه متابعة
إن أفلت المرء منها أولاً لم يفلت آخراً، كما يصاب الهدف حتماً على دقة
المرمى، وموالاة التصويب، وذلك هو تصريف الأمثال للناس، إنه إحاطة الإنسان
بسلسلة من المغريات المنوعة، لا معدى له من الركون إلى إحداها، أو معالجة
القلوب بمفاتيح شتى لابد أن يستسلم القفل عند واحد منها».(6)
الدعوة إلى الأدب الإسلامي:
عُرف الشيخ
في حياته الدعوية الحافلة بعاطفة جياشة، وحماسة فياضة تجاه المشكلات التي
تهم المسلمين، ومع أن أمر الدعوة قد أخذ منه جل وقته وجهده، ذلك لعظم
التحديات الحضارية التي واجهت الأمة الإسلامية في هذا العصر، والعمل
الإسلامي في حاجة ماسة إلى جهود العلماء المهيئين نفسياً وعلمياً للدفاع عن
الفكر الإسلامي، ينفون عنه تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتحريف
الغالين، ومع هذا العبء الكبير في الدعوة، عُرف عن الشيخ اهتمامه بقضايا
أخرى منها قضايا الأدب، فقد كان إنساناً يتذوق الشعر، يحفظ قديمه، ويتابع
جديده، وكثيراً ما كان يعكس هذا الذوق في كتاباته الدعوية المختلفة.
وحين
كتب كتابه القيم «مشكلات في طريق الحياة الإسلامية»(7) تناول واقع الأدب
ضمن المشكلات التي تعيق سبيل استئناف الحياة الإسلامية، ومن خلال عرضه
المتميز لهذه القضية نستشف أنه يدعو إلى أمرين، أولهما: الدعوة إلى الأدب
الإسلامي الحي الذي يدافع عن أمجاد الإسلام، المنبعث من قيم الإسلام
ومبادئه.
ثانيهما: الدعوة إلى رفض الأدب المنحرف بأشكاله كلها، ذلك أنه غاية يهدف إليها الاستعمار الثقافي، ودعاة الحداثة والتغريب.
يقول
في سياق حديثه عن جوانب النهضة الأدبية أيام «أحمد شوقي» و«حافظ إبراهيم»
و«الرافعي» وغيرهم: «إن هذه النهضة الأدبية المباركة كانت تبنى على المهاد
الأول، وتصل من أمجاد المسلمين ما أضاعه التفريط والغدر، وظاهر أن محافظتها
على التراث، وتقديسها للقيم الدينية، وولاءها العميق للغة العربية، أن ذلك
كله ثابت لا يتزحزح.. لكن الاستعمار الثقافي لم ييأس، وعداوته للغة القرآن
لم تفتر، إنه يريد القضاء على الإسلام، وأيسر السبل إلى ذلك القضاء على
العربية وقواعدها وآدابها، وأظنه اليوم قد بلغ بعض ما يشتهي، فقد اختفى
الأدب العربي الأصيل، وإذا وجدت كتابات بالحروف العربية فإنها وعاء لمعان
مبتوتة الصلة بأصولنا الروحية والفكرية».(8)
إن الشيخ يربط ـ كما هو
ملاحظ ـ بين النهضة الأدبية المباركة التي شهدها القرن الماضي وبداية هذا
القرن، وبين المحافظة على قيم الإسلام وتراثه الزاخر، حيث كان الأدب في
مجمله محافظـاً على إسلاميته وجذوره الدينية، وبرر فشل الاستعمار الثقافي
في محاولته تجفيف الروح الدينية في ميادين الأدب إلى تمسك أولئك الأدباء
بأصولهم الدينية، ومنطلقاتهم الإسلامية، ولم ينجح الاستعمار الثقافي في
غايته إلا حينما جّرد الأدب من روحه الإسلامي، فأصبح أدباً لا أصل له، وغدا
أدباً منحرفاً غريبا عن الثقافة الإسلامية، وهذا ما حفز الشيخ إلى الدعوة
إلى رفضه فقال: «إذا كان الأدب مرآة أمة، ودقات قلبها، فإن المتفرس في أدب
هذه الأيام العجاف لا يرى فيها ألبتة ملامح الإسلام ولا العروبة ولا أشواق
أمة تكافح عن رسالتها، وسياستها القومية، وثقافتها الذاتية، ما الذي يراه
في صحائف هذا الأدب، لا شيء إلا انعدام الأصل وانعدام الهدف، والتسول من
شتى الموائد الأجنبية، وحيرة اللقيط الذي لا أبوة له».
إن الأدب المنحرف
في أيامنا هذه هو فعلاً مثل اللقيط الذي لا أبوة له، بالإضافة إلى ذلك هو
كالشجرة الخبيثة التي قد تغري الناس بأوراقها الزاهية، ولكن طعمها كالعلقم،
وأثرها في الأرض وإن فشا سينعدم، {ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من
فوق الأرض مالها من قرار} (سورة إبراهيم، الآية 26).
دفاع عن العربية:
يُعد الشيخ
من أبرز الدعاة المنافحين عن اللغة العربية في هذا العصر، فقد كان دائماً
يصيح بحرقة: «اللغة العربية في خطر، أدركوها قبل فوات الأوان».(9)
والخطر
الذي يهدد اللغة العربية هو النتيجة الحتمية لتقاعس العرب عن أداء واجبهم
تجاه لغتهم، وتنفيذهم لخطة الاستعمار الثقافي الساعية إلى إلغاء دورها
الحضاري والفكري والثقافي، والقضاء على أداة التواصل بين الحاضر والماضي،
الأداة الجامعة لهذا الشتات المتقطع للعاميات في الوطن العربي.
ويرى الشيخ أن اللغة العربية تهان الآن بوسائل مختلفة:
أولاً:
بالروايات التمثيلية التي تحكي عبارات السوقة، والطبقات الجاهلة، فتحيي
ألفاظاً كان يجب أن تموت مكانها، وتؤدي إلى سيادة اللهجات العامية بدل
سيادة اللغة الجامعة، هذا إذا علمنا مدى الطاقات المادية والبشرية التي
تهدر من أجل انتشار هذا النوع من الأدب العامي.
ثانيا: بالحديث عن من هم
أهلٌ للقدوة من الزعماء وغيرهم الذين يحلو لهم أن يتحدثوا بلغة تجمع بين
الفصحى والعامية، ونحن ندرك جميعاً مدى التأثير السلبي الذي يعود على
المخاطبين عند سماعهم لهذه اللغة المضطربة، ومن البديهيات أن زعماء الدول
المتحضرة اليوم من أحرص الناس علي مخاطبة الجماهير بلغة راقية تجلب
الاحترام، ويرى الشيخ أن دعاة العروبة في هذا العصر هم من أعجز الناس عن
الحديث باللغة العربية.(10)
ثالثاً: وتهان العربية عند بعض أبناء
المسلمين الذين يريدون الانقطاع عن الثقافة الإسلامية، ويرون أن الحضارة هي
في تقليد الغربيين والحديث بلغتهم، والنظر إلى العربية على أنها لغة
متخلفة لا تساير العصر.
رابعاً: وتهان أيضاً في مجال الأدب، حيث اختفى
الأدب العربي الأصيل، وإذا وجدت كتابات بالحروف العربية فإنها وعاء لمعان
مبتوتة الصلة بأصولنا الروحية والدينية.(11)
ونشير إلى أن الشيخ قد
اقترح عدة مقترحات عملية لخدمة اللغة العربية في مجالات النحو والمعجم،
ولكنها إلى الآن لم تجد آذانا صاغية (12)
مواقف نقدية من الشعر المرسل:
ذكرت فيما
سبق أن الشيخ كان يتذوق الشعر ويحفظه، ويستشهد به في كلامه وفي كتاباته وفي
مواقفه المختلفة، ومع أنه كان مولعاً بالشعر القديم ـ وبخاصة شعر المتنبي ـ
إلا أنه كان يحفظ أيضاً الشعر الحديث ـ وبخاصة شعر أحمد شوقي ـ وكان يتابع
كل جديد ينشر في مجال الأدب والشعر ويقرأ للمعاصرين له، ولكنه كان يمقت
الشعر المرسل وما يسمى بقصيدة النثر، وكان يرى فيه ميداناً يتبارى فيه كل
عاجز، وقد برر موقفه النقدي هذا بقوله: «قد ظل العرب أقل من عشرين قرناً
يصوغون شعرهم حسب البحور المأثورة عنهم، حتى جاء هذا العصر الأنكد بما
يسمى: الشعر المرسل، محاكاة للشعر الأوربي كما يقولون.. وأكرهتني الأيام
على سماع هذا اللغو من بعض الإذاعات أو قراءته في بعض المجلات فماذا وجدت؟
تقطعا عقلياً في الفكرة المعروضة كأنها أضغاث أحلام، أو خيالات سكران.. ثم
يصب هذا الهذيان في ألفاظ يختلط هزلها وجدها، وقريبها وغريبها، وتراكيب
يقيدها السجع حينا، وتهرب من قيوده أحياناً، ثم يوصف المشرف على هذا
المخلوط الكيماوي المشوش بأنه شاعر!!».(13)
وقال في موضع آخر: «قد راقبت
إنتاج ذوي الأسماء اللامعة في هذا الميدان المبتدع، فوجدت السمة الغالبة
على هذا اللغو المسمى شعراً لا تتخلف أبداً، التفكير المشوش أو اللا تفكير،
والتعبير الذي يجمع الألفاظ بالإكراه من هنا ومن هنا، ويحاول وضعها في
أماكنها، وتحاول هي الفرار من هذه الأماكن.. والسؤال الذي يتردد باستمرار:
لماذا
أيها القوم تسمون أنفسكم شعراء إذا كنتم لا تحسنون قرض الشعر وبناء
القصيد، لماذا لا تحاولون أن تكونوا ناثرين بعد استكمال القدرة العقلية
واللغوية».(14)
إن هذا الموقف النقدي الذي قد يبدو متطرفاً أو مجانبا
للواقع، له مسوغاته العقلية والواقعية، فكثير من هذا الشعر مطبوع بطابع
الغلو في الرمز الذي يؤدي إلى الغموض الممقوت في الشعر، كما أن أغلبه يفتقد
إلى الموسيقى والإيقاع اللذين هما من أبرز خصائص الفن الشعري، ولعل خروج
هذا النوع من الشعر على الشكل القديم، وتفلته من قيود الوزن هو الذي أغرى
الناس ـ وبخاصة أهل التطفل على الفن ـ بقرضه والإكثار منه والدعوة إليه.
ومع
التقدير والاحترام اللذين نكنهما لوجهة نظر شيخنا هذه ، وذلك لعلمنا بحبه
لصدق الكلمة وبراءتها والتزامها، إلا أنه ومن باب الإنصاف في النقد القول
بأن الشعر المرسل ليس كله على هذا الشكل المذموم، والمعنى الغامض، فبعضه
يصدر عن شعراء قادرين على قرض الشعر، وتجتمع في شعرهم خصائص الشعر كلها، من
معان عميقة، وألفاظ موحية، ونظم بديع، بالإضافة إلى الموسيقى والإيقاع
اللذين لا غنى عنهما في الشعر.
إن التجديد في مجال الشعر أصبح حقيقة
فرضت نفسها في هذا العصر، سواء أكان التجديد في الأشكال أم في المضامين،
وأصبح الذوق الأدبي عند كثير من الناس يستجيب لهذا الشعر المحدث، ولكن مع
وجود التطفل على الفن الذي أدى إلى اختلاط الغث بالسمين، ووجود الحداثيين ـ
من أمثال «أدونيس» وغيره ـ الذين يروجون لقصيدة النثر في صورتها المعقدة
والغامضة حتى أصبحت كأنها أضغاث أحلام أو خيالات سكران ـ كما وصفها الشيخ ـ
ومع وجود مدارس نقدية تهتم بهذا الشعر وتسلط الضوء عليه، مع وجود هذا كله،
أصبحت الحاجة داعية إلى تقويم هذا السبيل، والدعوة إلى الشعر الذي يحمل
رسالة الحق والخير والجمال، الشعر الذي يضيف إلى رصيدنا الثقافي والفكري
شيئا له قيمة في الحياة.
خصائص أسلوبية متميزة:
هذه
وقفة سريعة للنظر في بعض خصائص الأسلوب عند الشيخ ـ رحمه الله ـ التي ميزت
طريقته في التعبير عن قضايا الفكر الإسلامي المختلفة، وجعلت كتاباته لها
مذاق خاص، وطابع فريد بين كتابات الدعاة في هذا العصر.
إن مما تنبغي
الإشارة إليه أن الشيخ متأثر تأثراً كبيراً بأسلوب القرآن الكريم، فقد كان
يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وكان يتحرى دائماً طرقه في دعوة الناس،
ولقد كان ذلك سر جمال أسلوبه، ولطافة تعبيره.(15)
ومن الخصائص الأساسية المميزة لأسلوبه ما يلي:
أولاً:
الأسلوب الأدبي هو الأسلوب المفضل في كتابات الشيخ، فهو يفضل عرض الأفكار
بلغة أدبية مؤثرة، فيها عناصر الإقناع والإمتاع، ويسير على هذه الطريقة في
جل ما يكتب، ولا يستخدم الطريقة السردية المباشرة إلا نادراً، وذلك لشد
عقول القراء وقلوبهم إلى الأفكار التي ينوي غرسها في النفوس.
ثانياً:
يتميز أسلوبه بكثرة استخدام الصور الفنية، والأمثال المحسوسة، ذلك لتقريب
الأفكار إلى النفوس، وعرضها في قوالب حية قريبة التناول، وواضح أن الشيخ قد
استمد هذه الطريقة من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية الشريفة.
ثالثاً:
يمتاز أسلوبه أيضاً بالتنويع المشوق، فهو يلون حديثه ويكثر من الأساليب
التي لها قدرة على التأثير كالاستفهام والتوكيد والتعجب، ويستخدم القصة
استخداماً جيداً، وكثيراً ما يتمثل بحوادث من الواقع، لتكون أبلغ في
التأثير، وأكثر التصاقاً بالقضايا المثارة في هذا العصر.
وبعد: فإن
الشيخ «محمد الغزالي» ـ رحمه الله ـ مثال (نادر) للداعية المتخصص في هذا
العصر، فقد جمع بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية، واجتهد في تقديم
الدعوة إلى الناس بلغة في الخطاب ممتعة، مما أكسبه احترام الناس، وبحق يمكن
القول: إنه مثال فريد للداعية الذي وضع الأدب في خدمة الدعوة.